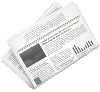إبراهيم عقيل الإنسان فاطمة عقيل السبت 20 أيلول 2025 عامٌ يمرّ، وما يزال الغياب يطرق الذاكرة كأنّه وقع البارحة. رحل إبرا
إبراهيم عقيل الإنسان
فاطمة عقيل
السبت 20 أيلول 2025
عامٌ يمرّ، وما يزال الغياب يطرق الذاكرة كأنّه وقع البارحة. رحل إبراهيم عقيل. دائماً ما كتبتُ في الرثاء وأجَدتُ وصف الراحلين، لكنّ حالي اليوم أصعب؛ إذ تخونني الكلمات... أهو عِظَمُ شأنه، فتستحي العبارات أن تقصر، أم أنّ القلب يأبى تصديق الرحيل، فيصمت العقل حفاظاً على ما اعتاد. غير أنّ عاماً مضى، والخبر يقين، والناس ما زالوا عطشى لمعرفة سيرته الخاصة، بعيداً من أدواره القيادية والجهادية.
كيف لرجلٍ واحد أن يجمع كلّ هذه الأدوار ويتقنها. قائدٌ ومعلّم، ابنٌ وأخ، عمٌّ وخال، زوجٌ وأبٌ وجدّ، وقبل كلّ ذلك عبدٌ صالح. وعندما سُئل يوماً عن هويته، أجاب: «أنا ابن الإسلام». واليوم، بعد عامٍ على الرحيل، أكتب عن إبراهيم عقيل الإنسان، ذاك الذي ملأ العائلة بحضوره، وترك بعد غيابه إرثاً من الوصايا والابتسامة والسكينة.
إبراهيم عقيل الابن
كان قليل الكلام، محدود المطالب، رغم أنّ أبواب الدنيا كانت مشرّعة أمامه. كان ذلك الابن البارّ الذي تجاوز دور الابن ليكون والد والديه. لا أنسى الحاج أبا حسن في شباط عام 2000، مهرولاً، محنيّ الظهر، عند علمه بمحاولة الاغتيال في باريش. رأيته كما لو أنّه الابن الباحث عن والده، وليس العكس. وحين حاولت تهدئته بطمأنته عن صحّته، أجاب: «إنّه أهمّ ما أملك، إنّه ولدي ووالدي وصديقي، إنّه ذخري لآخرتي». أمّا الحاجة أم حسن، فقد كانت «جنّته»، كما كان يسمّيها، فلم يكن يجلس إلا عند قدميها احتراماً وتبجيلاً. كان يراها أجمل الأمهات وأحسنهنّ، فلم يرضَ أن تُذكر بسوء ولو مزاحاً.
ورغم وضعه الأمني الصعب بعد حرب تموز، أصرّ على المداومة على زيارتها رغم التحذيرات. حتى إنه لم يتركها في المستشفى في آخر أيامها. وأذكر جيّداً حين رأيت دموعه للمرة الأولى، جالساً يقبّل قدميها وهي في الكفن، كان بحقّ ذلك اليتيم الذي فقد أجمل ما في دنياه. وبعد وفاة والديه، لم يمرّ عيد من دون حضوره عند قبريهما؛ فالبرّ لا ينتهي بالوفاة، كما كان يقول. ومن شدّة تعظيمه لشأن الأهل، كانت وصيّته لكلّ من عرفه: طاعة الوالدين، فالأمور لا تستوي من دون رضاهما.
إبراهيم عقيل الأخ
رغم كونه الأخ الأصغر بعد استشهاد أخيه «عبّاس» عام 1989، ظل المرشد والناصح، ومرجع العائلة عند كلّ معضلة. عنده الحلّ والربط، لا تُسوَّى الأمور من دون لمساته، حتى من بعيد. رغم قلّة الوقت، كان يسترق اللحظات في كلّ مناسبة ليجتمع بهم، وكان حريصاً على لقائهم كلّ عيد. كما لم تغب عنه أحوال أهل قريته بالعموم، وأرحامه من الدائرة الأبعد بالخصوص، فكان دائم السؤال عنهم. ومن التدبير الإلهي، وهو الذي لم يعتقد يوماً بالصدف، أن يصادف وقت وفاة أخيه، قبل عامين من استشهاده. حينها تواجد الحاج لثلاثة أيام في قريته بدنايل، رغم طلب الجميع منه المغادرة حرصاً على حياته. لكنّه بقي، مستقبلاً أهل قريته مبتسماً. وأذكر حينها أنّ كهلاً كبير السنّ أتى على عكازه لتقديم واجب العزاء، فقام الحاج من مكانه، رغم وجود عدد من الشخصيات، وجلس قرب الكهل ملاطفاً له، شاكراً إياه على قدومه.
كان الوالد قبل أن يكون العمّ أو الخال، كانت علاقته بهم جسراً يتأرجح بين الأبوّة والصداقة، رغم شحّ اللقاء. كان صديقاً مستمعاً، وأباً يمنح الطمأنينة والحنان، ومرشداً يضع المعالم الأساسية للوصول إلى الحلول. كان، كما يسمّونه، «وطناً صغيراً»، آمناً ودافئاً. علّمهم الصبر، وغرس في قلوبهم اليقين بأنّ الآتي أجمل، وكان يردّد أنّ الحبّ الأصدق والأوفى هو حبّ الله أولاً وأخيراً. أمّا وصيّته الأساسية، فكانت: الصلاة. وعليه، أصبحت وصاياه زاداً يحميهم عند تقلّب الأحوال.
إبراهيم عقيل الزوج والأب
لن أسهب كثيراً في هذا الدور، كون الحاج كان غيوراً في حياته. سأختصر بالقول: إن أردت أن تجسّد مفهوم الزوج بالتصوّر الإسلامي، لكان «إبراهيم عقيل». كان محبّاً عطوفاً محترماً، قليل الطلبات، كثير الشكر حتى على الواجبات: «قادرة تعمليلي إفطار... قادرة تكويلي القميص... شكراً... عذّبتك». لم يكن يوماً عائقاً أمام دراسة أو عمل، بل دائماً ما كان الداعم والمشجّع، حاملاً لفكر الإمام الخميني (قدس سره) والشهيد مطهري (رضوان الله عليه) في شؤون المرأة.
أما عن إبراهيم عقيل الأب، فكان له دوره «النوعي». كان لحضوره المحدود زمنياً، مقارنة مع بقية الآباء، أثره. إلا أنّه كان محيطاً بكلّ أحوالهم وتفاصيلهم. كان قريباً من أرواحهم، يرى ما لا يُقال، ويشعر بما يخفى. لم يكن قاسياً في تربيته، بل كان حنوناً، يمزج بين الجدّ والمزاح لإيصال الفكرة، ويربي أولاده على أدب الإسلام، لا بالعنف والتسلّط. كان يدلّهم على الخطأ قبل العقاب، ويشرح بتأنٍّ لماذا هذا الأمر مرفوض، وما هو الأفضل، مستشهداً دوماً بقوله تعالى: «ليبلوكم أيّكم أحسن عملاً».
كان العلم بالنسبة إليه قيمة عليا، إذ كان يحرص على الخوض في نقاشات مع أبنائه، كلّ في اختصاصه، وكان ملمّاً بتفاصيل كثيرة. لم يستعصِ عليه يوماً سؤال، بل كانت الأجوبة دائمةً حاضرة، مع تبسيط للمفاهيم لإيصال الفكرة. وكان يوصي بالقراءة، إذ كان يرى في الجهل عدواً. وهاجسه، بناء إنسان سليم، لا على خلق صورة مثالية أمام الناس، يدل على الطريق الصحيح، ويجهد لأن يكون أبناؤه نسخة محسّنة عن أنفسهم. لم يكن متصنّعاً ولا متكلّفاً، بل صادقاً حدّ الصفاء.
اما علاقته ببناته، فقد كانت لافتة، ويروي أحد الأصدقاء قوله: «إنّهنّ أعزّ أصدقائي، والوقت الذي أقضيه معهنّ هو وقت مقدّس». منذ الصغر، كنّ عندما يعلمن بقدومه يُجهّزن أنفسهنّ ترتيباً وأناقة، كأنّ ضيفاً عظيماً سيحضر. وعندما يصل، كان كلّ الوجود موجوداً بالنسبة إليهنّ. يسأل عن الرفاق والمدرسة بأدقّ التفاصيل. يلتفت إلى حزنهنّ من النظر في وجوههنّ، أو من نبرة صوتهنّ على الهاتف. لم يغب يوماً عن تفاصيل حياتهنّ حتى بعد الزواج، وازداد التواصل رونقاً واشتداداً. فكان هو المبادر للسؤال عنهنّ واحدةً واحدةً، وقد خصّص لهنّ يوماً في الأسبوع لعقد لقاء يضمّ بناته فقط، تحت مسمّى «الدرس الأسبوعي».
كان الدرس يتناول آية قرآنية يغوص فيها أخلاقياً وعقائدياً وفلسفياً وعرفانياً. وبالطبع، وفي الدرس، كثير من المزاح والضحك، وبعض الأناشيد والموسيقى التي أجاد عزفها. ولعلّ أكثر ما يخطر في بالي نشيد «أنين الروح»، الذي كنّ يتحلّقن حوله ينشدنه، وهو يلوّح بيده كمايسترو يمسك بيده كلّ مفاتيح السعادة. وكان لقاء الدرس يُختتم بحضن مشترك، يقف الأب متوسّطاً بناته وهنّ يعانقنه بشدّة، يتمتم معهنّ أنشودة لم يحفظ يوماً كلماتها، ثم يأتي دور القبلة على الرأس التي كان يطبعها على جبينهنّ واحدةً واحدةً. وحين حان موعد الوداع الأخير، كان الوداع استثنائياً، حيث تحلّقن حوله في النعش عند الوداع الأخير، ينشدن الأنشودة التي أحبّ أن يسمعها منهنّ: «أنين الروح».
إبراهيم عقيل الجدّ
عند سؤال أحفاده عنه، كان لافتاً أنه لم يكن الجدّ فقط، بل كان المربي والمعلّم والمرشد الروحي لهم. عند ولادة أيّ حفيد، كان يحضر في المستشفى رغم كلّ الظروف القاهرة والانشغالات، ليطمئن إلى صحة الأم أولاً، ثم ليقرأ الأذان والإقامة في أذنه، وهي كلمات تلامس القلب قبل الأذن. ينتظر الأحفاد حضوره ويتسابقون للجلوس بين أحضانه بمختلف الأعمار. يطرحون أسئلة جمعوها طوال الأسبوع. لم نحتج يوماً لإخباره بأنّ هماً ألمّ بأحدهم، كانت نظرة واحدة كفيلة بفضحهم، بينما حضن واحد كان كفيلاً بمسح الحزن من القلب.
له باع في مناقشتهم في كلّ شؤونهم، مهما كانت صغيرة، ومهما كان عمر الأحفاد، حتى الأطفال منهم. وكان كلامه منذ ولادتهم يملؤهم ثقة ويقيناً بالله. ويذكر حفيده جملة قالها له اختصرت جوهر الدين: «خلاصة الإنسان أمران: المسامحة، والإحسان لمن أساء إليك».
عند الحديث عن الحاج إبراهيم، يتبادر فوراً إلى الذهن صلاته وصيامه، إذ لا تخلو ذكريات من ركعتين. كان الحاج يتقدم إليهما، بعد صيام دائم ليومي الخميس والجمعة من كلّ أسبوع، وكذلك أيام شهري رجب وشعبان، ليكون الإفطار أفضل الوقت للاجتماع بالعائلة. عند دخوله المنزل، كان يدخل متشكراً على الدعوة: «عذّبتكن»، ثم يتوجّه إلى الصلاة مباشرة «ليلحق ركعتين قبل الأذان»، فيتسابق الأحفاد لفرش سجادة الصلاة، ثم لإحضار التمر والماء عند الأذان. ومن أجمل العادات التي أورثها للعائلة: تقديم الصلاة على الإفطار.
وعند الجلوس على المائدة، كان يوصي بعدم تعدد الأصناف فيها، ويظل يراقب الجميع ليتأكد أنّهم يأكلون. وبعد الإفطار، يتجمع حوله الأحفاد قبل الأهل لاحتساء الشاي، فيفتح موضوعاً، ليبدأ بالرد على أسئلة جُمعت من أسبوع إلى أسبوع، ثم يقرأ دعاء أو حديثاً. وحين المغادرة، كان الجميع يحاولون استراق قبلة على خدّه عبثاً، فكانت القبلة على الجبين مع حضن دافئ قبل المغادرة.
كان إبراهيم عقيل حكاية خاصة في بيته وبين أفراد عائلته، كل شيء خاص، نفس حضوره، جلسته، سكوته، نظرته، صدقه وحتى غضبه. كان استثنائياً في بساطته، وعظيماً في لطفه وحكمته... لذلك، لم يكن إبراهيم عقيل رجلاً عادياً...
ان ما ينشر من اخبار ومقالات لا تعبر عن راي الموقع انما عن رأي كاتبها