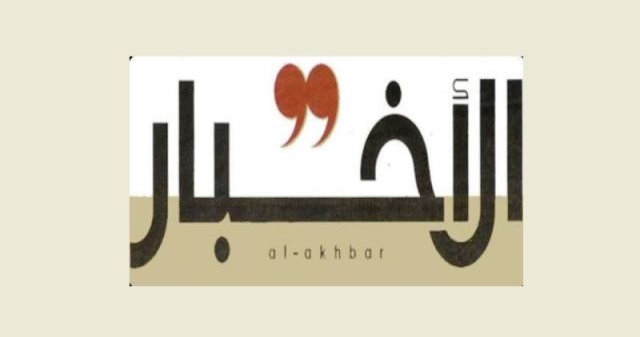عند عودتي إلى تلك الأرض العنيدة لدفن شهيدٍ وَرِثَ أطفاله عِبْء النضال قبل عبئية الأرض، راودني سؤال غير معهود: كيف أصبحت علاقتنا مع الشهادة؟ بعد مواراة جثمانه، عدنا إلى بيروت، بحتُ حينها لصديقي بأن معنى الشهادة لم يعد كما كانت... كيف لنا أن ندفن شهيدًا ونتابع «حياتنا اليومية» كأنّ شيئاً لم يكن؟ كأنّي أرى عيون الناس تصف الشهيد بالـ«عظمة، الشموخ، والبطولة» لكنها تعتبر نضاله «شأناً خاصاً به» بعيدًا كل البعد عن واقعنا وممارستنا اليومية. بالفعل، كأننا نرمي النضال كله للجبهة علّنا نستريح في حياتنا اليومية المتمدّنة. وحين تستيقظ فينا نزعة المقاومة نكتفي بتغريدة، بنشر صورة طفل غزاوي مقطّع، أو بنقاش جيوسياسي على حافة الرصيف. هنا تكمن الإشكالية التي تستدعي التفكيك: كيف أصبحنا نقاوم العدو بالظواهر، ونختزل النضال في طقوس نمارسها من بعيد، فنسلخ العدو من شموليته حتى يصير مجرد جانب منعزل، ونختصر المقاومة من نضال شامل إلى مجرد مهنة تُمارَس ثم تُطوى.
خذ مثلاً الطريقة التي نتحدث بها عن «الاقتصاد». فالمصرفي في بيروت يدّعي «فهم» الأزمة الاقتصادية من خلال مصطلحات تقنية: سعر الصرف، التضخم، السيولة - وكأنّ مأساة شعب بأكمله مجرد معادلة رياضية منفصلة عن الواقع المَعِيش. هذا «الفهم» هو أعمق أشكال العمى، لأنه يجرّد الظواهر الاقتصادية من نسيجها الاجتماعي ويسلب منها السياسي. فعندما تنهار الليرة اللبنانية، ما نشهده ليس مجرد «أزمة اقتصادية» بمعناها التقني بل نواجه منظومة عنف إمبريالية متكاملة تعيد إنتاج نفسها من خلال النظام المصرفي عينه (انظر إلى أثر الديون من قبل صندوق النقد الدولي وإلى «فعالية» التنمية النيوليبرالية والكارثة البيئية التي تُنتج منها). يحاجج علي القادري أن قانون الربح يستوجب تخفيض التكاليف، ما يفرض العسكرة، التي تتطلب بالضرورة نهب الأرض والموارد، أي قتل الإنسان. من هنا نفهم مثلاً أن استخراج النفط بحد ذاته ليس مصدر الربح الحقيقي، بل ما يدرّ الربح هو سلب قدرتنا على التفاوض على مصيرنا ومواردنا وعملنا ووجودنا. وعليه، فإن إبادتنا ليست حدثاً عارضاً بل تدمير «طبيعي» كي يتسنّى للنظام الإمبريالي نهب ثرواتنا وتسعيرها وفق منطق تراكم رأس المال. وهكذا، يصبح القتل والتدمير نمط الإنتاج المهيمن في عصرنا ويبقى ذاك المصرفي على «حياده» جازماً بـ«موضوعيته» و«علميته».
أتناول سؤال تجزئة العدو/ المقاومة الآن من منظور كلّي وخطابي نابع من غضبي، لا تحليليٍّ أكاديميٍّ. أصلًا: أيعقل أن نحلّل بالمنطق أمام مشروع لا يرى للعقل حضورًا؟ إنني على قناعة راسخة بأن المؤسسات الغربية و/ أو المستغربة - تربوية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية - حين تنخرط في منظومة الرأسمالية العنصرية والاستهلاكية والفردانية، فإنها تقوم بتربية وإنتاج ذاتٍ قادرة، حرفياً، على القتل والتدمير. فغاية هذه المؤسسات، تماماً كما كان في القرن الخامس عشر مبدأ «أنا أغزو، إذاً أنا موجود»، هي صناعة ذات إنسانية «أخلاقية» قادرة على القتل بشكل منهجي، مباشرةً أو مداورةً، من دون أن يخالجها أدنى شعور بالذنب. وإن فشلت هذه المنظومة بكل آلياتها في إنتاج الذات المطيعة القادرة على القتل، فإنها حتماً ستنجح في إنتاج ذات قادرة على الصمت في وجه القتل والإبادة. فتجزئة العدو هي ردة فعل تمارس من خلال الصمت والانتظار بأن الخطوط والقواعد تحدّد من قبل العدو، وتتجلّى في الواقع المادي عبر تقسيم العدو المناطق إلى مناطق «سلم» (غير شيعية؛ استراتيجية تعزّز الإسلاموفوبيا) ومناطق «حرب». ولعل فهم هذه التجزئة يستدعي النظر في جذورها التاريخية وارتباطها بتجربتنا المعقدة مع التحرر.
في القرنين التاسع عشر والعشرين نجحت حركات التحرر - من الجزائر إلى مصر إلى الثورة الإيرانية - في طرد المستعمِر عسكرياً، لكن ظلت أدواتنا المعرفية - من التعليم إلى التخطيط الحضري إلى مفاهيم الدولة والمواطنة - أسيرة ما يسميه أنيبال كيخانو بـ«الكولونيالية»؛ تلك التي تتجاوز وجود الاستعمار العسكري لتشكّل منظومة شاملة تسيطر على الاقتصاد والسلطة والمعرفة والذات والوجود. وكما يشير والتر مينيولو، الحداثة التي قُدمت لنا كخطاب للتقدم وللخلاص من الأزمات والـ«بربرية»، أخفت وراءها منطقاً كولونيالياً للقمع والاستيطان والاستغلال. والاستعمار، بمعنى استرقاق الشعوب ونهب ثرواتها، قاعدة الحداثة. وقد كرّست مختلفُ أشكالِ الإقصاءِ والمحو «النظامَ العالميّ الحديث»، أي النظام الاستعماريّ الرأسماليّ الأبويّ، ومركزيّته غربيّة مسيحيّة، بحسب رامون غروسفوغل، عالم الاجتماع البورتوريكيّ. تلك المنظومة ذاتها التي يجسّدها عدونا اليوم في كل ساحة من ساحات المواجهة: من السياسة إلى الاقتصاد إلى الثقافة إلى الوجود نفسه. فالتصنيفات العرقية والثقافية كانت نتاج الاستعمار منذ عام 1492، حين غزا كولومبس (الذي ظن أنه وصل إلى آسيا) جزر الكاريبي بهدف التبشير المسيحي والاستعمار و«اكتشف» أراضي شعب التاينو الأصلي في غواناهاني (التي أعاد تسميتها إلى سان سلفادور)، وهي جزء مما تعرفه الشعوب الأصلية بجزيرة السلاحف (ونعرفها اليوم بأميركا). لم تختفِ هذه التصنيفات مع رحيل الجيوش، بل تحولت إلى هياكل معرفية وسلطوية تُعيد إنتاج علاقات القوة اليوم.
كان الخطاب السائد حول الحرية يحوم في أفق «الاستقلال» و«السيادة» بدلاً من تطوير رؤية تحررية تنبع من تجاربنا وتراثنا المعرفي المغيّب والمنسي. فبعد «الاستقلال» المادي، ظهرت محاولات جادة لتأسيس خطاب معرفي مغاير (انظر/ي إلى تجربة محمد أركون في نقد العقل الإسلامي، ومحاولات سمير أمين في تفكيك التبعية الاقتصادية، كما برزت مساهمات نسوية عربية كأعمال فاطمة المرنيسي في إعادة قراءة التراث وليلى أحمد في تفكيك الخطاب الاستشراقي، وتكاملت هذه المساعي الفكرية مع حركات ميدانية نسوية ويسارية وإسلامية).
الأهم هنا أن «علاقتنا» مع هذه التجارب والمشاريع الفكرية بقيت في معظمها مغتربة عن العامّة، انعزالية، أو طائفية. فبدل أن تتحوّل هذه النصوص والأفكار إلى موارد حية ننتج من خلالها معرفة جديدة تتجاوب مع واقعنا الأورو - مركزي، بقيت مجرد «تجارب» نتحدّث عنها في المؤتمرات. بدلاً من بناء جسور تعاضدية جدّية مع هذه النصوص النقدية - مهما كانت - اكتفينا باستعراضها كشواهد تاريخية على «نهضة فكرية» لم تكتمل. فعندما نواجه اليوم قضايا كالعلاقة بين الريف والمدينة، أو بين التنمية والبيئة، أو إشكاليات الهوية والحداثة، نجد أنفسنا نستعير مفاهيم وتحليلات غربية و/ أو مستغربة (انظر/ي إلى كل مقال في صحفنا في لبنان) بدل تطوير أدوات تحليلية تنبع من فهمنا لمشاريعنا النقدية السابقة ومن خصوصية تجربتنا التاريخية. هذا الانفصال يعكس أزمة على صعيد الابستيمولوجية في علاقتنا بإنتاج المعرفة وبقدرتنا على تحويل التراث النقدي إلى أداة للتغيير الاجتماعي والسياسي. المطلوب، إذاً، ليس إحياء هذا التراث، بل إعادة تأسيس علاقتنا مع هذه النصوص والمشاريع الفكرية إلى موارد حقيقية وحية ومنتجة للمعرفة نبني عليها ونستخدمها ونتبادلها وننقدها ونتقنها ونعيد صياغتها ونستشرف من خلالها مستقبلاً مختلفاً لمشاكلنا وأزماتنا الحداثويّة/الكولونيالية. وعليه، إذا كان الاستعمار يتجدّد في آن - رغم أسطورة «السيادة» لدى «الفينيقيين» - وإذا كان الشارع اللبناني اليوم لا يشهد أي نواة لنضال حتى في لحظة يسقط فيها بغزة شهيد تلو شهيد وتُمحى فيها قرى جبل عامل قرية تلو قرية، فأيّ تحرر معرفي ندّعي؟
لنعد الآن إلى الشهيد - الشهيد لم يدخل ساحة المقاومة، تاركاً خلفه حياة بأكملها، من باب المهنة أو رومانسية النضال، بل الظروف المادية في تفاعلها مع وعي الصراع الوجودي، هي التي شقت له درب المقاومة. فمقاتل اليوم لا يحمل السلاح عشقاً للقتال، ولا هواية في الحرب، ولا إجباراً على المواجهة. إنه يقاتل لأن المقاومة أضحت، في وعينا الجمعي، خيارنا الأخير والوحيد. يقاتل، ببساطة، كي يحيا. وعليه، فإن الدَّين الحقيقي لشهدائنا يبدأ بالاعتراف بأن كل موقع في المجتمع هو موقع محتمل للنضال. إننا نقاوم أو نرضخ. هذه هي المعادلة. تجزئة العدو والمقاومة تُفرض بقوة البطش والقتل والهيمنة حين يصبح عملي المقاوم خارج مهنتي، وممارستي النضالية خارج الساحة العامة، وممارسات ديني وتقاليدي داخل منزلي فقط، وفكري النقدي خارج عملي الجامعي.
وها نحن الآن يقع علينا عبء اتخاذ موقف، والنضال حتى لو أخذ منا كل ما نملك. هذا هو ثمن وجودنا في هذا الحيّز من الأرض وهذا الزمان. علينا أن ندرك تداعيات العلاقات المغيّبة (انظر/ي كيف يتم استخراج الكوبالت في الكونغو لصناعة بطاريات هواتفنا). علينا أن نفهم حجم المسؤولية التي نتحملها، وأننا إذا لم نتصرف وفقاً لها - الآن - فسنفشل، للأسف، في أن نكون قد عشنا حقاً. علينا أن نفهم أننا قد سئمنا من الإمبريالية، سئمنا من الديون الاستعمارية، سئمنا من الحروب والغزوات العسكرية. علينا أن نقرأ ونستوعب كيف تتم الهيمنة علينا. علينا أن ندرك قوة هيمنتهم، وشراسة بطشهم العسكرية وقوة الهيمنة المعرفية التي لامست حرفيّاً كل شيء. إذا لم نسعَ جماعياً للبحث عن إجابات والنضال من أجل حقنا في الوجود، أي إذا استسلمنا للهيمنة الخارجية الإمبريالية وأشكالها وألوانها في الداخل من الفاشية والانعزالية والسياسة القطبية والطائفية العنصرية باللباس المحلّي، فسنصبح مثل الإماراتيين ودبي نبني ناطحات سحاب ونزيّنها بالصور كلما حصلت أزمة... وما أقبح هذا العيش!
فإمّا أن تكون المقاومة شاملة تبقَر كل لحظة من لحظات النهار والليل، أو لا تكون. وإما أن تكون الحياة مقاومة، أو لا تكون.
كاتب